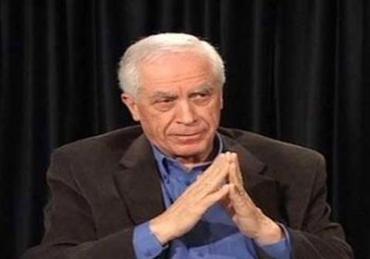هل يفعلها الرئيس محمود عباس؟
لكل حالة مرضية أعراضُها، وتحديد هذه الأعراض وتحليلها هو الذي من شأنه أن يقود إلى طريق التشخيص الصحيح. والتشخيص الصحيح، كما يعلمنا علم الطب، هو نصف العلاج.
ويرتبط بهذه الحقيقة حقيقة أخرى وهي أن على المريض أن يدرك أصلًا أنه مريض، وأنه بحاجة إلى علاج ويسعى إليه سعيًا، وإلا فإن إنكار المريض لحالته المرضية يشكّل حالة مرضية في حد ذاتها (A State of Denial).
نقطة البداية إذًا أن نعترف، وبدون أي مواربة، أن نظامنا السياسي يعاني من حالة مرضية معقدة، وعلينا أن ندرك حقيقتها وتداعياتها ونسعى بكل جدٍّ وهمة لعلاجها والخروج منها قبل أن تستفحل أكثر وتستعصي.
لا يمكن في عجالة سرد كل أعراض حالتنا المرضية وسبل علاجها، على مختلف الأصعدة. ولكن من الممكن والضروري على الأقل الإشارة إلى أهم الأعراض الأساسية التي يعاني منها نظامنا السياسي لعلنا نصل إلى تشخيص صحيح يوفر لنا نصف طريق العلاج.
أولًا: هناك خلل في عقل نظامنا السياسي تجلّى أكثر ما تجلى في الدخول في اتفاقات أوسلو. فأي عقلٍ سياسي يوقّع على الرسائل التي سُميت برسائل "الاعتراف المتبادل " والتي تعترف بحق إسرائيل في الوجود، مما يعطي الصهيونية مشروعية لروايتها مقابل روايتنا الفلسطينية؛ كما تلتزم فيها قيادة م. ت. ف. بالتخلي عن الإرهاب (وليس بمجرد نبذه) مما يعترف ويوصم الكفاح الفلسطيني وحركة تحرره بالارهاب.
أي عقل سياسي ذاك الذي يوقع اتفاقًا تشير ديباجته إلى اعتبار الأراضي الفلسطينية (الضفة الغربية وغزة) وحدةً جغرافية واحدة، بينما مضامين ونصوص متن هذا الاتفاق لا تضمن تواصلًا مُحكمًا بين الضفة وغزة، وتسلخ القدس عن هذه الضفة سلخًا وتقرر لها مصيرًا انتزعها عن متناول المرحلة الانتقالية وألقى بها إلى مصيرٍ محتوم، ضمن قضايا الحل النهائي، وهو مصير التهويد الذي تصارعه القدس الآن. ثم تتجلى ديباجة "الوحدة الجغرافية الواحدة" المزعومة فيما بعد بتفتيت تلك الجغرافيا إلى (أ) و(ب) و(ج)!
كما أدى هذا الخلل الدماغي الذي أصاب عقلنا السياسي إلى قبول تأجيل البت في أمر الاستيطان ليلقى مصير قضايا الحل النهائي، دون أن يجرؤ هذا العقل السياسي المعطوب حتى على ربط توقيع اتفاق أوسلو في حديقة زهور البيت الأبيض بتجميد الاستيطان، ولو مجرد تجميد، رغم أن شريك اتفاق "سلام الشجعان" ذاك كان إسحاق رابين الذي كم تترحّم قياداتنا عليه و يشدها الحنين إلى ذكراه. ناهيك عن عدم اشتراط توقيع اتفاق أوسلو بالإفراج عن الأسرى كما تفعل حركات التحرير التي لا تنسى أسراها.
على أن ذروة هذا الخلل الذي أصاب عقلنا السياسي تجسدت في تلك المهزلة المأساة المسماة التنسيق الأمني. لم يحدث في تاريخ حركات التحرر الوطني سابقة كهذه: حركة تحرر وطني تنسق أمنيًا مع عدوها!
ثانيًا: يصاحب هذا الخلل الدماغي في عقلنا السياسي عرض مرضي آخر لا يقل خطورة ألا وهو فقدان الإرادة.
فرغم أن كل الوقائع والدلائل تشير إلى فشل المسار ألذي تم سلوكه منذ أكثر من عشرين عامًا ، وخطورة الاستمرار في هذا المسار، ليس هناك من إرادة جادة وحقيقية لتغيير هذا المسار وسلوك مسار بديل بكل الزخم والإعداد الجدي الذي يتطلبه ذلك.
لا زال التردد والانتظار طاغيًا.
لم نحسم أمرنا من اتفاقات أوسلو بعد.
لم نحسم أمرنا من التنسيق الأمني بعد.
لم نحسم أمرنا من عقم ما يسمى بالرباعية الدولية رغم خضوعها الكامل للإرادة والشروط الإسرائيلية ونسعى لترقيع عورتها بورقة توت عربية.
حتى المفاوضات لم نحسم أمرنا بالتعامل معها ووضعها في سياقها الطبيعي كجزءٍ لا يتجزأ من إستراتيجية متكاملة عمادها المقاومة الشعبية بأشكالها المتنوعة، فتأتي المفاوضات تتويجًا، وليست خيارًا بديلًا لتغييرٍ ملموس في ميزان القوى يجبر إسرائيل على الخضوع لمطالب الحقوق الوطنية الفلسطينية. لقد مارسنا هذه المفاوضات كخيار وحيد، وبعد أن قمنا بإسقاط كل أو أغلب أوراق القوة من أيدينا بدلًا من استجماعها. لم يحدث في حركات التحرير سابقةٌ كهذه. فلا يجوز مجرد التفكير بدخول المفاوضات، أية مفاوضات، ونحن في موقع ضعف، وإلا أصبحت مفاوضات عبثية لا طائل من ورائها سوى أنها تمنح الإسرائيليين الوقت الذي يريدونه لاستكمال وتعميق مشروعهم الصهيوني الاستيطاني الأستعماري، كما تمنحهم غطاء يظنونه يمكّنهم من التصدي للزخم المتنامي لحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات حركة B.D.S)).
ولا يغيّر من شأن هذه المفاوضات شيئًا حتى لو أتت بحلّة فرنسية، أو بالأحرى حيلة فرنسية ربما تهدف إلى الالتفاف على المحكمة الجنائية الدولية!
ثالثًا: وعَرَضٌ ثالث للحالة المرضية التي نعاني منها هي فقدان الرؤية والبصيرة وبوصلة تحديد الاتجاهات والأوليات. وأسطع دليل على هذا أنه رغم حقيقة أن الإنقسام يدمرنا ويشل قدراتنا على مواجهة التحديات والمخاطر التي تواجهنا فإننا لا نخطو خطوة واحدة جادةً حقيقية لإنهاء الانقسام، مهما كان الثمن. علمًا أن الخطوة الجادة والحقيقية في ذلك الإتجاه إنما تتمثل في الدعوة الفورية لإنعقاد الإطار القيادي المؤقت ل م. ت. ف. كتجسيد للقيادة الوطنية الموحدة. فهذاالعناد، وهذا الإصرار على وضع الفيتو على انعقاد الإطار القيادي المؤقت غير مفهوم وغير مبرر بل وغير مسموح ٍ استمرار الإمعان فيه رغم انه يشكل الخطوة الأولى، والتي لا بديل عنها من أجل السير باتجاه إنهاء الانقسام أولًا، ومن اجل اعادة بناء م. ت. ف. على أسس جديدة ثانيًا، ومن أجل توفير حاضنة ورافعة وقيادة لما نشهده من إرهاصات الإنتفاضة الحالية وما يليها.
وبكل بساطة وبكل الوضوح أقول: من يرفض أو يعرقل الدعوة الفورية لعقد الإطار القيادي المؤقت إنما يرفض إنهاء الإنقسام وإنما يرفض اعادة بناء م. ت. ف.، وإنما يرفض توفير مقومات الصمود والإستمرارية و النجاح للفعل الشعبي المقاوم
أجل، من يرفض أو يعرقل الدعوة الفورية لعقد الإطار القيادي المؤقت ل م. ت. ف. إنما يرفض إنهاء الانقسام، وإنما يرفض إعادة بناء م. ت. ف. ، وإنما يرفض توفير مقومات الصمود والاستمرارية والنجاح للفعل الشعبي المقاوم.
كما يتجلى عَرَضٌ فقدان الرؤية وبوصلة تحديد الاتجاهات في هذا الإنحدار المتسارع نحو الاستبداد، رغم اننا شاهدنا ونشاهد يوميا عواقب ومآلات وخرابات أنظمة الاستبداد من حولنا. ففي حين نرى هذا التيار الجارف يطيح بأنظمة الاستبداد والشمولية من حولنا ، نجد الإستبداد والشمولية يزحفان نحونا ويتغلغلان بين ظهرانينا.
وإلا فماذا نسمي تغوّل اجهزة الأمن في العديد من مناحي حياتنا وتدخلها في مجالات، ومؤسسات، و قرارات لا شأن لها بها ؟؟ وتقتطع ثلث ميزانيتنا على حساب مخصصات التعليم والصحة والزراعة ، ومع هذا لا تستطيع أن تكف يد مستوطن واحد عن مزارعٍٍ يقطف الزيتون، ولا أن توقف مستوطنًا لمخالفة مرورية
ماذا نسمي تراجع استقلال القضاء ونزاهته؟
ماذا نسمي تضييق الخناق على الحريات العامة بما فيها حرية الرأي والتعبير، و حق التجمع السلمي والتظاهر؟
ماذا نسمي بعض مظاهر تراجع حرية الصحافة وخضوعها للرقابة الذاتية، وغير الذاتية، إرضاء ً لذوي السلطة بشقيها المدني والأمني، ولبعض ذوي رؤوس الأموال احيانًا ؟
ماذا نسمي المؤشرات المتسارعة على تركز السلطات الثلاثة بيد السلطة التنفيذية، ضاربة ً بعرض الحائط المبدأ الدستوري بالفصل بين السلطات كمبدأ مقدس؟
ماذا نسمي غياب الآلية الواضحة والمقننة لاتخاذ القرار؟
ماذا نسمي غياب مبدأ الشفافية والمحاسبة؟
ثم ماذا نسمي هذه النظرة المتشككة حينا والعدائية حينًا آخر، ومنذ إنشاء السلطة الوطنية، تجاه مؤسسات المجتمع المدني ومنظماته الأهلية، وخلط صالحها بطالحها، مما يقوّض أحد الأـعمدة الثلاثة الأساسية لأي مجتمع عصري. فكما أن هناك سلطات ثلاث: التنفيذية والتشريعية والقضائية، هناك أيضًا مؤسسات ثلاث:
* مؤسسات حكومية تعمل على هامش السلطة التنفيذية ولها دور هام وأساسي في تقديم وتطوير الخدمات للمجتمع، ومنها الصالح والطالح.
* ومؤسسات المجتمع المدني ولها دورها المهم والأساسي في كل مجالات حياة المجتمع، ومنها الصالح والطالح.
* ثم هناك ثالثًا مؤسسات في القطاع الخاص، منها من يمتلك قيم المسؤولية المجتمعية وتقدم برامج من وحيها، ومنها أيضًا الصالح والطالح.
فتقويض وتشويه النظرة إلى مؤسسات المجتمع المدني على امتداد حيزها Across the Board ، بخلطٍ تام، وبدون تمييز ودون ضوابط ومعايير من شأنه أن يؤدي إلى الإطاحة بهذا العماد الهام للمجتمع، خاصة بالنسبة لنا نحن الفلسطينيون الذين لعب مجتمعنا المدني ومؤسساته الأهلية، ولا يزال، دورا أساسيا، متقدمًا وطليعيًا، في مواجهة الإحتلال وتحديات التنمية والصمود تحت الاحتلال، قبل قيام السلطة بعقود، وما بعد ذلك، وحتى يومنا هذا.
إذا لم لم يشكل كل هذا المشهد من أمامنا انزلاقًا نحو الاستبداد والشمولية، فماذا بربكم يكون؟!
والأهم من ذلك ماذا بربكم نحن فاعلون للخروج من حالتنا المرضية المأزومة، وأين طريق الخلاص؟
هل من طريق للخلاص من دون أن ننهي الانقسام ونستعيد وحدتنا الوطنية؟
أقولها بصوتٍ عالٍ: لماذا لا يتوجه الرئيس محمود عباس فورًا إلى غزة لعقد الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير هناك، ولا يغادرها قبل إرساء أسس استعادة الوحدة الوطنية، وقبل الاتفاق على مسارٍ جديد لحركتنا الوطنية.
هل يرضى الرئيس محمود عباس لنفسه بصفته آخر القادة المؤسسين لمنظمة التحرير أن يظل هذا الانقسام المدمر وصمةً في إرثه التاريخي، أم أن يدخل التاريخ من أوسع أبوابه قائدًا فعل المستحيل لإنهاء الانقسام ، قائدًا قلب الطاولة ووضع شعبه على الخطوة الأولى لمسار جديد، طال انتظاره، ولا بديل له نحو الخلاص. فهل يفعل؟
إذا لم يفعلها الرئيس محمود عباس، وهو القابض على آخر ما تبقى لنا من رموز الشرعية، فمن غيره بقادر على ذلك؟
وإذا لم يفعلها الرئيس محمود عباس الآن الآن، فمتى إذًا، أبعْدَ خراب البصرة؟